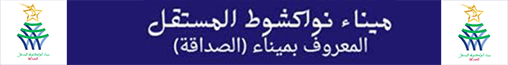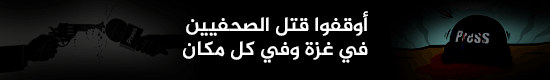تشهد موريتانيا توجها إصلاحيا جديدا في الإدارة المالية يتمثل في اعتماد مشاريع سنوية للأداء تربط الأهداف والمؤشرات بالميزانية العامة ،وقد أصدر وزير المالية مؤخرا مقررا يلزم القطاعات الحكومية بتحويل ميزانياتها إلى ميزانيات برامج بحلول 2026م، بحيث تحدد كل وزارة أهدافا واضحة ومؤشرات أداء لكل برنامج مع متابعة منتظمة للتنفيذ، ويلزم هذا التوجه رفع تقارير أداء سنوية إلى وزارة المالية واعتماد هيكلة برامجية ذات أهداف قابلة للقياس تعزيزا للشفافية وتحقيقا للنتائج ،ويعكس هذا الإصلاح توجها عالميا نحو التخطيط الإداري المبني على النتائج أو ما يعرف بالإدارة بالأهداف ودمج التخطيط الاستراتيجي مع عملية إعداد الميزانية
في هذا المقال التحليلي نستعرض الأسس النظرية لهذا المفهوم ذو الطابع المؤسسي ونبين أثره على الحوكمة والشفافية وفعالية الأداء في المؤسسات العامة ، كما نقارن تجربة موريتانيا بنماذج متقدمة مثل المغرب ورواندا ،ونوسع نطاق النقاش لاستشراف تأثير التخطيط القائم على الأهداف على مجالات حيوية أخرى كصيانة المرافق والنظافة العامة وأداء البلديات وشركات خدمات الماء والكهرباء، إضافة إلى استقرار الأسعار وإدارة الأزمات مع اقتراح حلول عملية تراعي خصوصية الواقع الموريتاني
الإطار المفاهيمي للتخطيط الموجه بالنتائج
يعتبر التخطيط وفق الأهداف والمؤشرات منهجية حديثة في الإدارة العامة تستند إلى مبادئ الإدارة بالأهداف وإدارة الأداء بالنتائج، ويرتكز هذا النهج على تحديد أهداف واضحة قابلة للقياس كخطوة أولى ثم صياغة خطط عمل لتحقيقها ومتابعة التنفيذ عبر مؤشرات أداء رئيسية وربط تخصيص الموارد المالية بتحقيق تلك الأهداف بدلا من الصرف التقليدي على بنود مدخلاتفقط، وقد برزت هذه الفكرة منذ الخمسينيات عبر أعمال بيتر دراكر وغيره ،حيث تؤكد نظرية الإدارة بالأهداف أن تحديد أهداف مشتركة بوضوح ومراجعة النتائج دوريا يوجه جهود المؤسسة بكفاءة أعلى ويحقق أداء أفضل بأقل تكلفة
وفي سياق الإدارة الحكومية الحديثة تطورت هذه المفاهيم إلى ما يعرف بالميزانية الموجهة بالأداء أو ميزانية البرامج حيث يتم تصميم الموازنات العامة وبرامج الإنفاق وفق الأهداف الإستراتيجية المراد بلوغها والنتائج المتوقعة منها ،وهذا التحول يمثل جزء من موجة إصلاحات الإدارة العمومية عالميا المعروفة بالإدارة العمومية الجديدة والتي تسعى إلى إدخال أساليب القطاع الخاص القائمة على الأداء والمسائلة إلى القطاع العام
وعلى المستوى النظري المؤسسي يستند التخطيط بالأهداف إلى فرضية أن وضوح الأهداف وارتباط الموارد بتحقيقها يعززان الانضباط والالتزام داخل المؤسسات فبدلا من التركيز على مجرد إنفاق المخصصات يصبح الاهتمام موجها نحو نتائج ذلك الإنفاق، لذا يتطلب الأمر وجود هياكل مؤسسية وتنظيمية تدعم هذا النهج مثل وحدات للتخطيط الاستراتيجي والرصد والتقييم في كل وزارة ,ونظم معلومات لجمع البيانات عن المؤشرات وإطار قانوني يلزم الجهات بتقديم تقارير عن أدائها
وقد تبنت العديد من الدول إطارا قانونيا يسمى القانون العضوي للميزانية يحدد الانتقال إلى ميزانية البرامج، ففي موريتانيا مثلا صدر قانون مالي جديد عام 2018م يمهد لاعتماد هذا النهج وعملت وزارة المالية على تطوير نظام معلوماتي لإعداد وتنفيذ الميزانية وهو مانتج عنه إصدار التوجه الجديداعتبارا من 2026م ،كل ذلك يأتي لضمان ترسيخ التخطيط بالأهداف مؤسسيا وليس كمجرد إجراءات معزولة ،وبشكل عام يمكن القول إن التخطيط الموجه بالأهداف والنتائج يمثل نقلة نوعية من ثقافة الإدارة بالتسيير اليومي إلى ثقافة الإدارة الإستراتيجية التي تربط التخطيط بالتمويل ثم بالأداء
من التركيز على الإنفاق إلى التركيز على النتائج
يتميز النهج التقليدي لإعداد الميزانية بكونه مدفوعا بالمدخلات حيث ترصد الأموال على أساس بنود الإنفاق ،مثل الرواتب والمعدات والمباني دون ربط واضح مع ما سيتم تحقيقه ميدانيا أما الميزانية حسب البرامج والأهداف فتنقل التركيز إلى المخرجات والنتائج ،أي أن كل برنامج حكومي يتضمن أهدافا محددة، مخرجات كمية أو نوعية، ويتم ربط اعتمادات الميزانية بتحقيق تلك المخرجات وفق مؤشرات قياس محددة، فعلى سبيل المثال بدلا من أن تمنح وزارة التربية ميزانية عامة للتعليم دون شروط يتم تخصيص موارد لكل برنامج مثل برنامج للتعليم الأساسي أو برنامج للتعليم الثانوي مع اشتراط تحقيق مؤشرات أداء مثل رفع نسبة النجاح المدرسي بنسبة معينة أو تخفيض معدل التسرب
وبنهاية العام يتم تقييم مدى تحقيق هذه المؤشرات مقابل ما صرف من ميزانية، وتؤخذ النتائج بالاعتبار عند إعداد ميزانية العام التالي، وبهذه الطريقة يصبح التخطيط المالي أداة لمتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية، وليس مجرد عملية محاسبية جافة
ويعزز هذا الأسلوب مبدأ المسائلة أيضا، إذ يصبح كل جهاز حكومي مسؤولا أمام الجهات الرقابية وحتى الجمهور عن نتائج الأموال التي أنفقها، كما يسمح بقدر من المرونة الإدارية حيث يتم منح القائمين على البرامج صلاحيات أوسع في إعادة توجيه الموارد بين أوجه الإنفاق المختلفة لتحقيق أهدافهم ما دامت ضمن البرنامج، ومع ذلك يشترط هذا النهج توفر بيانات موثوقة لقياس الأداء وتحديد أهداف ذكية تكون محددة وقابلة للقياس والتحقق وذات صلة ومرتبطة بجدول زمني
نحو عقلية إستراتيجية في المؤسسات العامة
من منظور نظري مؤسسي يمثل التخطيط بالأهداف نقلة في ثقافة المؤسسات العامة نحو التوجيه الاستراتيجي بدلا من الإدارة الروتينية، إنه يستنهض روح الفريق بتحويل الرؤية والأولويات الوطنية إلى أهداف عملية يشعر فيها كل موظف بدوره في تحقيقها، وعندما تتبنى الحكومة هذه الثقافة تصبح الرؤية الإستراتيجية للدولة مثل خطط التنمية الوطنية مرتبطة مباشرة ببرامج الوزارات ومشاريعها السنوية، وهذا الربط العمودي من الاستراتيجيات العليا وصولا إلى موازنات الجهات القاعدية يضمن اتساق الجهود وتحويل الرؤى إلى إنجازات ملموسة
ويتيح التخطيط بالأهداف أيضا اكتشاف الاختلالات مبكرا فعندما تتم مراجعة النتائج دوريا تظهر المؤشرات المجالات التي لم تحقق تقدما ,مما يمكن من تصحيح المسار أو إعادة تخصيص الموارد حسب الحاجة، فمثلا إذا كان أحد أهداف وزارة الصحة مثلا خفض وفيات الأمهات بنسبة معينة خلال العام ولم يتحقق التحسن المرجو بعد تقييم فصلي أو بعد التقييم السنوي ، حينها يتم تحليل الأسباب ، فقد يكون السبب نقص تجهيزات أو فجوات في التكوين و التدريب، بالتالي يمكن تعديل الخطط أو زيادة وتوجيه بعض الموارد لمعالجة القصور ،وهكذا تتحول عملية الميزانية إلى حلقة مستمرة من التخطيط والتنفيذ ثم التقييم
ونظريا ينتج عن هذا النهج تراكم الخبرات حول ما ينجح وما لا ينجح في تحقيق الأهداف العامة ،وبمرور الوقت يترسخ ما يمكن تسميته ثقافة الأداء في الجهاز الحكومي حيث يتبنى الموظفون عقلية تحقيق النتائج وخدمة المؤشرات المستهدفة كمعيار للنجاح بدلا من ثقافة تنفيذ الأنشطة
الأثر على الحوكمة والشفافية والفعالية والكفاءة
إن اعتماد التخطيط الموجه بالأهداف وربط الميزانية بالمؤشرات لا يعد مجرد تغيير فني في أسلوب الإدارة المالية بل له انعكاسات مؤسسية عميقة على منظومة الحوكمة والإدارة العامة وفيما يلي أبرز تأثيراته على الحوكمة والشفافية وفعالية السياسات وكفاءة استخدام الموارد
تحسين الحوكمة وتعزيز المساءلة: يفرض هذا النهج تحديدا واضحا للمسؤوليات عن كل برنامج وهدف ،فبعد أن كانت النتائج العامة سابقا مسؤولية جماعية فضفاضة بات كل وزير أو مدير برنامج يعرف ما المتوقع تحقيقه بالأرقام في مجاله، وهذا الوضوح في الأدوار يقابله آليات للمسائلة حيث يسائل البرلمان أو مجلس الوزراء المسؤولين عن مدى تحقيقهم لأهدافهم السنوية ،على سبيل المثال عندما ترفع تقارير الأداء السنوية لوزارة المالية ويتم نشر خلاصاتها يمكن للنواب والجمهور معرفة أي وزارة حققت مستهدفاتها وأيها قصرت
وقد أكد خبراء الإصلاح المالي أن الهدف من إصلاح المالية العامة هو تحسين تنظيم وعمل الدولة وجعل تدخلاتها أكثر شفافية وفعالية وكفاءة ومن هنا يشجع التخطيط بالأهداف نهج الإدارة المبني على النتائج الذي يتطلب قياس أداء الأجهزة الحكومية بانتظام وبالتالي يرسخ مبادئ الحكم الرشيد
زيادة الشفافية والثقة العامة: يوفر ربط الأهداف بالميزانية مستوى أعلى من الشفافية في إدارة المال العام فالمواطن العادي يصبح قادرا على الاطلاع ليس فقط على حجم الإنفاق في قطاع معين بل ماذا حقق هذا الإنفاق، وعندما تنشر بيانات مثل بناء 100 مدرسة جديدة وتحسين نسبة النجاح الدراسي بنسبة 5% مقابل مبلغ محدد فإن ذلك يعزز ثقة الجمهور بأن الميزانية تستخدم لتحقيق منافع ملموسة، وقد أشارت تقارير دولية إلى أن الشفافية ومشاركة المواطنين والمسائلة في عملية الميزانية تؤدي إلى فساد أقل وإيرادات أعلى وخدمات عامة أفضل وأكثر كفاءة ،وبهذا المعنى يصبح الانفتاح جزءا أصيلا من المنظومة, فالمؤشرات المعلنة والنتائج المرصودة متاحة للتدقيق العام مما يصعب التستر على سوء استخدام الموارد أو ضعف الأداء، كما أن الرقابة البرلمانية على تنفيذ الميزانية تتطور من رقابة شكلية على أرقام الإنفاق إلى رقابة نوعية على جودة المخرجات ، وقد شهدت دول عديدة تحسنا في مؤشر شفافية الموازنة الدولي عند انتقالها لميزانية البرامج كما حصل في المغرب وتونس خلال السنوات الأخيرة نتيجة نشر تقارير أداء سنوية وإشراك المجتمع المدني في تقييمها
رفع فعالية السياسات العامة : تعني الفعالية مدى تحقيق السياسات لأهدافها وعندما يتم تصميم الموازنة حول أهداف محددة تصبح السياسات أكثر تركيزا ووضوحا فتتحدد أولويات الحكومة بجلاء، فمثلا إذا كان الهدف الاستراتيجي خفض معدل البطالة إلى نسبة معينة سيظهر ذلك في برامج الوزارات المعنية مثل التكوين المهني والتشغيل، وهكذا يتم موائمة الميزانية مع الهدف المنشود فلا تتشتت الجهود أو تتداخل البرامج بلا تنسيق، كما أن التخطيط بالأهداف يتيح تقييم فعالية كل برنامج عبر مؤشرات الأداء فإذا تبين أن برنامجا معينا لم يحقق أثره المتوقع رغم صرف كامل ميزانيته يمكن تعديل تصميمه أو استبداله بسياسة أنجع وهذه المراجعة التقييمية المستمرة تزيد فعالية الإنفاق العام بتحويل الأموال نحو البرامج الأكثر جدوى
زيادة الكفاءة وتقليل الهدر : تعني الكفاءة تحقيق الأهداف بأقل تكلفة ممكنة وحين تربط الحكومة التمويل بالأهداف يتم تشجيع الإدارات على ترشيد الإنفاق وإعادة توزيع الموارد نحو البنود التي تعطي نتائج أفضل، فالمسؤول عن برنامج ما يعرف أنه سيقيم على أساس نسبة الإنجاز مقارنة بالإنفاق مما يدفعه للبحث عن أكثر السبل فعالية وكفاءة لتحقيق النتائج، مثل اعتماد التكنولوجيا لتخفيض الكلفة أو الشراكة مع القطاع الخاص عند الاقتضاء، وبما أن المؤشرات تتضمن عادة قياسا للكفاءة مثل تكلفة الخدمة للوحدة أو نسبة الإنجاز لكل أوقية مصروفة فإن جوانب الهدر والإنفاق غير المنتج ستنكشف بسهولة، وقد بينت الدراسات أن الميزانية القائمة على الأداء تمنح صانعي القرار أدوات تحليلية لاتخاذ قرارات مبنية على معلومات حول كفاءة البرامج، فمثلا إذا كان هناك برنامجان لتحقيق نفس الهدف الاجتماعي لكن أحدهما يحقق النتائج بنصف الكلفة مقارنة بالآخر ستتجه الحكومة لإعادة تخصيص الموارد لصالح البرنامج الأكفئ، وبذلك ينخفض الهدر الناجم عن التكرار أو سوء التوزيع، ومن ناحية أخرى يسمح هذا النهج بإعادة توجيه الموارد خلال العام المالي إذا تبين أن بعض الأهداف تحققت بأقل من المتوقع من الموارد، حيث يمكن نقل الفائض لبرنامج آخر أكثر حاجة ضمن ضوابط مالية واضحة، وهذا النوع من المرونة في إدارة الموارد يعتبر أحد عوامل رفع الكفاءة في الاستخدام
تجارب متقدمة في التخطيط القائم على الأداء ( المغرب و رواندانموذجا)
للوقوف على أفضل الممارسات في مجال التخطيط وربط الميزانية بالأهداف يجدر بنا استعراض نماذج ناجحة طبقت هذا النهج بشكل متقدم مثل المغرب أو رواندا وفيما يلي لمحة عن تجربة كل من هذين البلدين :
أولا : تجربة المغرب
تبنى المغرب خلال العقد الماضي إصلاحا شاملا في إدارة المالية العامة تمثل في الانتقال إلى ميزانية مبنية على البرامج والأداء، ففي عام 2015 صدر قانون إطار مالي وهو القانون التنظيمي لقانون المالية 130-13 يؤسس لهذا التحول وبدأ تطبيق ميزانية البرامج بشكل كامل ابتداء من قانون مالية 2018م، وقد ارتكزت هذه الخطوة على أهداف واضحة أبرزها الانتقال من تصنيف الميزانية حسب طبيعة الإنفاق إلى تصنيفها حسب الوجهة أي البرامج وربط الاعتمادات المخصصة لكل برنامج بمؤشرات أداء تقيس النتائج وتعزيز مسؤولية الإدارات العمومية عبر منحهم مرونة أكبر لتحقيق أهدافهم مقابل محاسبتهم على النتائج المحققة، وقد شمل الإصلاح جميع الوزارات دون استثناء تقريبا مما اضطر كل قطاع إلى صياغة إستراتيجيةقطاعية واضحة بأهداف محددة ،كما وضع القانون ترتيبات لمتابعة الأداء وتقييمه سنويا وألزم الحكومة بتقديم تقارير أداء لعرض مستوى تحقيق كل قطاع لأهدافه
ما ميز النموذج المغربي هو وجود متابعة ومواكبة فنية مستدامة قادت الإصلاح على مدى سنوات، فتم إنشاء وحدات متخصصة داخل وزارة الماليةلتوجيه ودعم الوزارات في إعداد خطط نفقات متوسطة المدى وتطوير مؤشرات ملائمة، كما تم إعداد أدلة منهجية وتنظيم دورات تدريبية للموظفين حول مبادئ إعداد البرامج والمؤشرات وهو مشابه لتوجه بلادنا حاليا، وإحدى نقاط القوة أيضا في إصلاح المغرب هو شموليته ومرونته ،إذ لم يقتصر على الوزارات المركزية بل شجعت أيضا المؤسسات العامة والجماعات المحلية على اعتماد موازنات موجهة بالأهداف لتحقيق التكامل على مستوى الدولة، وحتى بالنسبة للجهات التي يصعب قياس أدائها مثل الجهات السيادية أو الإدارية البحتة تم إيجاد حلول مثل مخصصات موحدة أو مؤشرات نشاط بدلا من النتائج الكبرى كي لا يعطل ذلك تقدم الإصلاح
ونتيجة لهذه الجهود بدأت تظهر ثمار إيجابية، فبعد السنة الأولى من التطبيق الكامل في المغرب أظهرت المتابعة انخراطا حقيقيا من طرف الوزارات وثقافة جديدة قائمة على النتائج داخل الإدارة العمومية المغربية كما ارتفع مستوى شفافية الميزانية المغربية دوليا حيث تقدمت في ترتيب مؤشر الميزانية المفتوحة بفضل نشر معلومات الأداء وبرامج الميزانية للجمهور، والأهم برزت تحسينات نوعية في إدارة المشاريع العامة، فمثلا تمت مأسسة تتبع تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية عبر مؤشرات تقيس الأثر الاجتماعي والاقتصادي مثل خفض الفقر المحلي أو تحسين معدل التغطية الصحية مما ساعد في تحديد الاختناقات ومعالجتها
وباختصار يتسم النموذج المغربي بالشمولية والرسوخ القانوني وامتلاك القدرات الفنية مما ضمن له الاستمرارية وقد أثبت قدرته على تحسين شفافية وفعالية الإنفاق العام وخلق مناخ من المسائلة داخل الإدارة ،حيث أصبح الوزراء يقدمون إجابات بلغة الأرقام عن نتائج قطاعاتهم أمام البرلمان، ومثل هذا النموذج يمثل مرجعا مهما لموريتانيا وهي تدخل في تجربة مماثلة خاصة أن السياقين متشابهان إلى حد كبير من حيث الطابع الفرنكفوني في الجانب المالي وتقارب التحديات التنموية
ثانيا : تجربة رواندا
أما رواندا فقد سلكت نهجا مختلفا نوعا ما ،يركز على الإدارة بالأهداف عبر كافة مستويات الحكم من المركز إلى القاعدة، فقد اعتمدت رواندا منذ عام 2006م منظومة عقود الأداء المعروفة محليا باسم "إيميهيغو"، وهي تقليد ثقافي تم تحديثه ليصبح أداة حكومية فعالة ،ففي إطار الإيميهيغو يقوم كل مسؤول بدءا من الرئيس والوزراء وصولا إلى المحافظين ورؤساء البلديات ومدراء المدارس بتحديد حزمة أهداف سنوية علنية يتعهد بتحقيقها ضمن نطاق مسؤوليته ويتم توقيع هذه الأهداف كعقد أداء ويقيم الإنجاز في نهاية الفترة ،وما تلك التجربة هو شمولها لكافة القطاعات مثل التعليم والصحة والزراعة والبنى التحتية وتنسيقها مع خطط التنمية الوطنية مثل رؤية رواندا 2020م، ثم إستراتيجية التحول الوطني الأولى، كما يرتبط رصد الميزانية في رواندا بتحقيق الأنشطة المندرجة تحت هذه العقود فلكل مؤشر أو هدف هناك مستوى تمويل مرصود ويتم متابعة الإنفاق مقابل التقدم في المؤشر
وقد أثبت نموذج الإيميهيغو في رواندا نجاعة كبيرة في تسريع التنمية المحلية وتحسين الخدمات، فخلال عقد من تطبيقه تمكنت رواندا من تحقيق معظم أهداف الألفية التنموية قبل عام 2015م، وانخفض معدل الفقر من 57% عام 2005م إلى 39% في عام 2014م، ويرجع البنك الدولي وغيره جانبا من هذا النجاح إلى منظومة الأداء الصارمة التي نشرتها عقود الإيميهيغو، فقد ولدت روحا من المنافسة الإيجابية بين المسؤولين المحليين لتحقيق أعلى النتائج خاصة أن تقييم الأداء ينتهي عادة بمكافأة المعنيين ذوي الأداء المتميز ومساءلة المقصرين، فمثلا شهدت الخدمات الصحية والتعليمية تحسنا ملحوظا حيث ارتفعت نسب إتمام التطعيمات وانخفضت وفيات الأمهات في مناطق عدة نتيجة التزام المحافظين بأهداف محددة في الصحة، كما ازدادت معدلات التحاق الأطفال بالمدارس وانخفضت معدلات الأمية مع تبني أهداف تعليمية محلية في كل مقاطعة، بل إن دراسات أكاديمية وثقت أن توقيع عقود الأداء ساهم في خلق وظائف جديدة بنسبة 72% وتحسين عمل التعاونيات بنسبة 69% وتحسين حياة الأسر الأشد فقرا في المناطق التي شملتها تلك العقود وهذه أرقام تدل على مدى تأثير نهج الإدارة بالأهداف إذا ما نفذ بحزم واستمرارية
وتكمن نقاط القوة في التجربة الرواندية في عنصرين أساسيين هما اللامركزية المقرونة بالمسائلة الصارمة وترسيخ الأداء كثقافة وطنية، فالنهج لم يكن تقنية مالية فحسب بل أصبح جزءا من الحوكمة المحلية حيث يشارك المواطنون أيضا في تحديد أولويات الأهداف في مناطقهم ويعرفون ما تعهد به مسؤولوهم مما عزز الثقة والتعاون بين المجتمع والإدارة ،كما أن التقييم السنوي العلني للأداء خلق ضغطا مجتمعيا إيجابيا يدفع الجميع لبذل أقصى الجهود، ولأن الإيميهيغو متصلة بخطط التنمية طويلة الأجل مثل رؤية 2050م، فإنها تضمن الاتساق والاستمرار في تحقيق غايات إستراتيجيةعبر خطوات تكتيكية قصيرة المدى تتجدد سنويا وبالطبع هناك خصوصية للسياق الرواندي من حيث الانضباط العالي وقدرات التنفيذ، لكن مبادئ التجربة قابلة للتكييف
لاشك أنه بالنسبة لموريتانيا قد لا يتطابق النموذجان المغربي والرواندي تماما مع واقعها، لكن كليهما يقدم دروسا قيمة فمن المغرب تبرز أهمية الإطار القانوني والمؤسسي والدعم الفني لبناء قدرات التخطيط ورصد الأداء ،ومن رواندا تظهر قوة إشراك جميع المستويات الإدارية ووضع أهداف ملموسة تفهم من قبل المواطن العادي، والجمع بين النموذجين قد يكون الأنسب ، أي تبني ميزانية البرامج والأداء كإطار مالي وطني كما في المغرب ،مع محاولة غرس ثقافة العقود الأدائية على المستوى اللامركزية لتحفيز البلديات والجهات على تحسين الخدمات كما في رواندا
توسيع نطاق التفكير و أثر التخطيط بالأهداف على مجالات أخرى
لا يقتصر تأثير التخطيط المرتكز على الأهداف والنتائج على مجالات الإدارة المالية وتتبع أثر الإنفاق ،بل يمتد ليشمل العديد من الجوانب الحياتية والخدماتية التي تهم المواطن ومن أبرزها صيانة المنشآت العمومية ونظافة المرافق العامة وأداء البلديات وأداء شركات الماء والكهرباء، واستقرار الأسعار وإدارة الأزمات والمخاطر ،فجميع هذه المجالات تعاني محليا من مشكلات تراكمية يمكن أن يسهم التخطيط الممنهج بالأهداف في معالجتها وتحسينها بشكل ملموس
صيانة المنشآت العمومية : تعاني كثير من الأصول العامة مثل الطرق والمدارس والمستشفيات والمباني الحكومية من تدهور سريع بسبب غياب خطط صيانة منتظمة ومرصودة التمويل، والتخطيط بالأهداف يمكن أن يغير ذلك عبر وضع أهداف صريحة لمستويات الصيانة يجب تحقيقها سنويا، فمثلا يمكن لوزارة التجهيز تحديد هدف رفع نسبة الطرق المصنفة في حالة جيدة من 60% إلى 80% خلال ثلاث سنوات وترصد في الميزانية برنامجا خاصا لصيانة الطرق بمؤشرات قياس، مثل عدد الكيلومترات المعاد تأهيلها وزمن الاستجابة لإصلاح الحفر، وبنهاية كل سنة يقاس ما تحقق وتتم مسائلة المعنيين عن أي قصور ومعرفة أسبابه سواء كان نقص تمويل أم ضعفا في الإدارة أو عوامل خارجية ،وبهذا النهج تتحول الصيانة من بند إنفاق هامشي جزافي يمكن تأجيله إلى أولوية لها مردود اقتصادي كبير ،إذ تؤكد الدراسات أن كل أوقية تنفق وقائيا في الصيانة توفر عدة أضعافها من كلفة الإصلاح الكلي لاحقا
نظافة المرافق العمومية : كثيرا ما تهمل جوانب النظافة في المرافق العامة، كالمباني الحكومية الإدارية والمستشفيات والشوارع رغم تأثيرها المباشر على الصحة العامة وصورة المدينة، ومن خلال التخطيط بالأهداف يمكن تطوير عمل الجهات المسؤولة أو استحداث جهات جديدة لسد هذه الفجوة ، من خلال وضع مستهدفات كمية لتحسين مستوى النظافة ، كما يمكن وضع مؤشر لرضا المواطنين عن نظافة المرافق من خلال استبيانات دورية كمعيار أداء ،وقد نجحت مدن عالمية عديدة في تحسين النظافة بفضل خطط واضحة وتخصيص تمويل كاف وتجهيزات مناسبة بناء على أهداف محددة مثل تجربة رواندا في جعل العاصمة كيغالي من أنظف مدن إفريقيا نتيجة سياسات صارمة، وفي موريتانيا يمكن أن يؤدي تبني هذا النهج إلى تحسن ملحوظ في نظافة المرافق الحكومية والأسواق والشوارع في نواكشوط عبر تحفيز شركات النظافة بمؤشرات أداء مثل عدد جولات الكنس يوميا في كل حي ونسبة التغطية، والنتيجة ستكون بيئة صحية وجذابة وانخفاض بعض الأمراض المرتبطة بالتلوث وتعزيز الشعور العام بالرفاه
أداء البلديات والحكامة المحلية: البلديات بوصفها حكومة محلية معنية مباشرة بالخدمات الأساسية، غالبا ما تعاني من ضعف القدرات وغياب معايير تقييم واضحة، وإدخال التخطيط بالأهداف على المستوى البلدي من شأنه رفع كفاءة أداء البلديات بشكل كبير ويمكن أن تطلب الدولة من كل بلدية إعداد خطة سنوية تتضمن أهدافا محددة في اختصاصاتها وتدخلاتها ،مثل معيرة الاستفادة من الإعانات أو تسهيل استخراج الوثائق المدنية في زمن قياسي مع مؤشرات متابعة لكل هدف
وتخصص موارد من ميزانية البلديات بناء على تلك الخطط، ويتابع التنفيذ كل ربع سنة، مثل هذا الإجراء سيخلق روح المنافسة بين البلديات لتحسين ترتيبها في أداء الخدمات ،وقد جربت دول عديدة تصنيفا لأداء البلديات سنويا مع ربط النتائج بحوافز مالية إضافية للأفضل كما في بعض برامج البنك الدولي للتنمية المحلية الموجهة للدول النامية ،مما أدى إلى تحسن شامل في الإدارة المحلية
وفي موريتانيا يمكن لوزارة الداخلية واللامركزية تبني نظام تقييم سنوي للبلديات وفق مؤشرات محددة، مثل نسبة إنجاز المشاريع الممولة ومستوى رضا المواطنين المحليين وتحسن الجباية المحلية، وإعلان النتائج مع تقديم دعم فني للبلديات الضعيفة لتحسين أدائها، وبهذا سنشهد خلال بضع سنوات تقلص الفوارق بين البلديات وتحسن نوعية الخدمات في عموم البلد وتترسخ المحاسبة المحلية حيث يعرف المواطن ماذا حققت بلديته مقارنة بالموارد التي تلقتها
أداء شركات المياه والكهرباء : خدمات المياه والكهرباء تعاني من تحديات كبيرة خصوصا خلال فترة الصيف،وهنا أيضا يمكن اعتماد أسلوب العقود الأدائية مع الشركتين، فمثلا توقع الحكومة عقد برنامج مع شركة الكهرباء يتضمن مؤشرات أداء سنوية مثل خفض نسبة انقطاع التيار بعدد ساعات محدد أو توصيل الكهرباء لعدد محدد من القرى الجديدة ،ويربط جزء من الدعم الحكومي أو الامتيازات بتحقيق تلك المؤشرات وهذا الأسلوب مستخدم في بعض الدول حيث يتم تحديد مستويات مستهدفة للخدمة في عقود الإدارة
ومن جهة أخرى يمكن لوزارة المياه وضع برنامج وطني لتحسين نفاذ الماء الصالح للشرب يحدد أهدافا مثل رفع نسبة السكان المخدومين بالمياه من مستوى إلى آخر أعلى وتمويل مشاريع الآبار والشبكات بناء على ذلك، ووجود هذه الأهداف الواضحة يحفز الشركات المشغلة على تحسين أدائها لأنها تعلم أن تقييم أدائها مرتبط مباشرة برضى الدولة والمواطنين عما تحقق من أهدافها، ففي رواندا مثلا أدرجت أهداف إيصال المياه والكهرباء ضمن عقود أداء المسؤولين المحليين مما نتج عنه توسع سريع للشبكات خلال فترة وجيزة ،وفي موريتانيا يمكن قياس تحسن خدمات الكهرباء بمؤشر عدد ساعات انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنويا أو مؤشر تكرار الانقطاع، وتحسن خدمات المياه بمؤشر نسبة توفر الماء يوميا وعدد القرى المخدومة حديثا، وتقديم هذه البيانات علنا
السيطرة على الأسعار والتضخم : استقرار الأسعار يمثل هاجسا لأي حكومة بسبب أثره المباشر على معيشة المواطنين ورغم أن الأسعار تتأثر بعوامل خارجية إلا أنه يمكن للحكومة اعتماد أهداف محددة تتعلق بالتضخم وأسعار المواد الأساسية ضمن سياساتها الاقتصادية وربط بعض التدخلات بتحقيقها ، ويمكن تتبع مؤشر أسعار المستهلك شهريا كأحد مؤشرات الأداء الاقتصادي للحكومة كما يمكن وضع هدف أدق مثل الحفاظ على استقرار أسعار بعض المواد الأساسية طوال العام ضمن هامش تقلب 3% مما يعني رصد بنود دعم في الميزانية كافية أو بناء مخزون استراتيجي لتحقيق هذا الهدف، ومثل هذه الأهداف السعرية تضبط إيقاع السياسات المالية، فإذا لوحظ ارتفاع كبير في أسعار سلعة أساسية يتم إطلاق إنذار مبكر لأن المؤشر المستهدف مهدد فتتخذ الحكومة إجراء فوريا مثل إعفاء جمركي مؤقت أو زيادة الدعم أو تعجيل الاستيراد
ولاشك أن القياس الدوري لمستوى أسعار بعض المواد الأساسية ومقارنته بالمستهدف يضفي شفافية ويعزز مصداقية العمل الحكومي، وفيما يتعلق بالتضخم يمكن الاسترشاد بتجارب دول نجحت في احتواءه بنفس نظام المؤشرات والأطر المستهدفة، مثل تجربة المغرب ومصر مؤخرا حيث أصبح البنك المركزي يعلن مستهدفاته ويحاسب عليها، وفي موريتانيا قد يكون من المفيد إنشاء مرصد وطني للأسعار يقوم بوضع ونشر تقارير شهرية عن المؤشرات السعرية مقارنة بالمستهدفات المعلنة
إدارة الأزمات والمخاطر : لقد أبرزت أزمات السنوات الأخيرة من جائحة كورونا إلى الفيضانات ، أبرزت أهمية وجود خطط استباقية لإدارة الأزمات و التخطيط المبني على الأهداف بحيث يشمل أهدافا تتعلق بالجاهزية للأزمات ضمن خطط الحكومة، مثلا يمكن لمختلف القطاعات خصوصا المرتبطة بالأزمات الصحية والكوارث وحتى الأزمات الأمنية، أن تضع رؤية توضح آلية وكيفية وكذلك زمن الاستجابة ، هذا مع رصد ميزانيات لتدريبات ومحاكاة سنوية لكيفية التعاطي مع تلك الأزمات،فوجود عقلية التخطيط بالأهداف في إدارة المخاطر يجعل البلاد أكثر مرونة وصلابة في نفس الوقت لأنه يخلق دائرة تعلم مستمرة،وبهذا يرتقي مستوى إدارة الأزمات من رد الفعل إلىالاستباقية
خصوصية موريتانيا والحلول العملية المقترحة
رغم المزايا الكبيرة للتخطيط والميزانية الموجهة بالأهداف إلا أن نجاح تطبيقه في موريتانيا يعتمد على ملائمة النهج لواقعها المؤسسي والوطني فلكل بلد خصوصياته من حيث البنية الإدارية والثقافة التنظيمية ومستوى الموارد البشرية والفنية المتاحة، و فيما يلي نناقش أهم الاعتبارات الخاصة بموريتانيا ونطرح حلولا عملية تضمن تبني هذا الإصلاح بشكل سلس وفعال ومستدام
تعزيز القدرات المؤسسية وبناء الكفاءات: يمثل نقص الخبرات في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء تحديا في العديد من الوزارات الموريتانية لذلك من الضروري الاستثمار بقوة في التكوين والتدريب، وعلى صعيد آخر لا بد من تطوير نظم المعلومات إذ أن نجاح النهج يعتمد على البيانات، ولذا من الضروري بناء منصة مركزية لمتابعة مؤشرات الأداء لجميع القطاعات وربطها بقواعد بيانات الإحصاء الوطني ( لوحة قيادة رقمية على مستوى الوزارة الأولى تعرض بشكل لحظي أو بشكل دوري مستوى تقدم كل وزارة في مؤشراتها الأساسية مقارنة بالهدف المخطط )، مثل هذا النظام الإلكتروني سيكون أداة فعالة للمراقبة والتنسيق واتخاذ القرار المناسب
المرحلية والتجريب ثم التعميم: من الحكمة تطبيق الإصلاح تدريجيا لتفادي إرباك الجهاز الإداري ولمعالجة العقبات في نطاق ضيق قبل تعميمها ،وقد انتهجت بلادنا هذا الأسلوب فعلا حيث نجحت أربعة قطاعات حكومية في تطبيق ميزانية البرامج خلال 2025م بشكل تجريبي مما قدم دروسا قيمة لتوسيع نطاق الإصلاح لباقي القطاعات، و في 2026م نقترح الاستمرار في هذه المنهجية، من خلال التركيز على عدد محدود من المؤشرات المهمة في كل وزارة بدلا من محاولة قياس كل شيء منذ البداية،إذ يمكن اعتبار هذه الفترة مرحلة انتقالية يتم فيها إرساء النظم وبناء الثقافة المؤسسية دون التشدد كثيرا في ربط النتائج بالمسائلة الصارمة
أيضا قد تظهر خلال التطبيق التجريبي مشكلات في جودة المؤشرات المختارة، كأن يتضح أن مؤشرا معينا غير عملي أو لا تتوفر له بيانات، وهذا طبيعي لذا ينبغي المرونة في تعديل المؤشرات وتحسينها باستمرار، مثلا على سبيل المثال إذا وجدت وزارة الصحة صعوبة في قياس تحسن جودة الرعاية الصحية كمؤشر عام يمكن تجزئته إلى مؤشرات فرعية أكثر قابلية للقياس مثل معدل انتظار المرضى في المستشفيات أو نسبة توفر الأدوية الأساسية، المهم هو عدم اعتبار الخطة جامدة بل مخططا حيا يتطور
الدعم السياسي والمأسسة القانونية : نجاح أي إصلاح إداري يتطلب دعما سياسيا مستمرا على أعلى مستوى، و في الحالة الخاصة ببلادنا من الضروري أن تواصل القيادة السياسية رؤيتها المميزة و إعطاء أولوية لهذا التوجه عبر متابعة دورية لتقدم الوزارات في هذا المضمار وتشجيعها، فيمكن مثلا من كل 3 أشهر وخلال اجتماعات مجلس الوزراء أن تقدم كل وزارة تقريرا عن أدائها المرحلي وما حققته من أهداف ، كذلك ينبغي تعزيز الإطار القانوني الناظم حتى مع وجود قانون عضوي للمالية 2018م يدعم ميزانية البرامج، إذ نقترح إصدار نصوص تطبيقية تفصيلية ،مراسيم أو قرارات وزارية توضح الأدوار والمسؤوليات لكل جهة، دور وزارة المالية في الإشراف والتدقيق، دور وزارة الشؤون الاقتصادية في موائمة المؤشرات مع خطط التنمية، دور المفتشية العامة في ضمان مصداقية البيانات، وكذلك تعزيز دور البرلمان في هذه المنظومة ربما عبر تعديل النظام الداخلي للجمعية الوطنية بحيث تخصص جلسات لمناقشة تقارير الأداء السنوية للقطاعات الرئيسية مما يحفز الوزراء على الاهتمام بجدية النتائج المصرح بها
تحسين جودة البيانات والإحصاءات الوطنية : أحد أكبر المخاطر في تطبيق إدارة قائمة على المؤشرات هو الاعتماد على بيانات ضعيفة الجودة أو ناقصة ،ما قد يؤدي إلى قرارات خاطئة أو صورة مضللة عن الأداء، لذا من الأولويات الاستثمار في تحسين منظومة الإحصاء الوطني،كما يجب دعم المكتب الوطني للإحصاء ليكون قادرا على إجراء مسوح ميدانية دورية تغطي مؤشرات التنمية الرئيسية مثل الفقر ،البطالة،التعليم والصحة لتغذية المؤشرات الإستراتيجية، وعلى مستوى كل وزارة ينبغي إنشاء أو تفعيل وحدات للرصد والتقييم مزودة بخبراء إحصاء وأنظمة معلومات تكون مسؤولة عن جمع وتحليل بيانات الأداء ورفعها للإدارة العليا بشكل موثوق، أيضا قد تحتاج بعض المؤشرات إلى اعتماد تعريفات ومعايير موحدة حتى يمكن المقارنة والتتبع المستمر،مثلا يجب الاتفاق على كيفية حساب نسبة البطالة أو معدل الأمية بشكل موحد وشفاف كي تكون الأهداف مبنية على أسس مستقرة، ومن المهم إشراك الشركاء الدوليين كالبنك الدولي والأمم المتحدة الذين غالبا ما يمتلكون مبادرات لدعم القدرات الإحصائية في الدول النامية
إشراك المجتمع المدني والإعلام لضمان زخم مستدام ولتعزيز الشفافية : من المفيد إشراك أطراف خارج الحكومة في مراقبة وتقييم الأداء ،يمكن تشجيع مراكز الأبحاث الوطنية والجامعات على إصدار تقريرات موازية تحلل مدى تحقيق الأهداف الحكومية المعلنة ومدى كفاية الموارد المخصصة لها كذلك، كما يمكن للإعلام القيام بدور إيجابي عبر تتبع تنفيذ المشاريع السنوية وتسليط الضوء على النجاحات والإخفاقات، و ربما يمكن التفكير أيضا في إطلاق بوابة الكترونية للجمهور تقدم بيانات مفتوحة عن المؤشرات الوطنية ومدى التقدم فيها
التحفيز والتغيير الثقافي : لا يمكن إغفال البعد الثقافي داخل الإدارة فالموظفون اعتادوا لعقود على نمط عمل معين وربما يتوجس بعضهم من النظام الجديد لأنه سيجلب مزيدا من التقييم وربما المسائلة على التقصير لذا من المهم تهيئة بيئة مشجعة لهذا التحول بدلا من بيئة عقابية صارمة، فمنذ البداية يمكن مثلا استحداث جوائز سنوية لأفضل وزارة حققت مستهدفاتها أو لأفضل فريق تخطيط قدم تقرير أداء نموذجي وذلك لتعزيز روح المنافسة الإيجابية
كذلك يجب أن يقترن التركيز على المسائلة بترسيخ ثقافة التعلم وعدم الخوف من الفشل، أي تشجيع الوزارات على الإفصاح بشفافية عن عدم تحقيق هدف معين وشرح الأسباب،إذ قد يكون الهدف طموحا جدا أو الظروف غير مواتية دون أن ينظر لذلك كخسارة بل كفرصة للتعلم والتحسين، هذا التوازن الدقيق مهم جدا كي لا يلجئ المسؤولون إلى التلاعب بالمؤشرات أو وضع أهداف متدنية سهلة التحقيق لمجرد تجنب النقد، ولمنع ذلك يجب ان تأتي التوجيهات من القيادة العليا بأن هدفنا الإصلاح الحقيقي وليس تجميل الأرقام وأن الإخفاق في تحقيق هدف طموح بشفافية خير من تحقيق هدف هزيل لا يفيد المواطن، وفعلا إذا تشرب الموظفون هذه الرسالة سيصبحون شركاء حقيقيين في عملية الإصلاح ويقدمون أفضل ما لديهم بصدق
وفي الختام يمكن القول بأن:
بلادنا تخوض اليوم مرحلة مفصلية في تحديث إدارة ماليتها العامة وتحسين فعالية مؤسساتها عبر تبني نظام التخطيط بالأهداف والمؤشرات وربط ذلك بالميزانية ،وكما استعرضنا فإن هذا التوجه له أساس نظري راسخ في الفكر الإداري الحديث وقد أثبتت التجارب الدولية سواء في محيطنا كالمغرب أو على الصعيد الإفريقي كرواندا أن التركيز على النتائج بدلا من المدخلات يولد إدارة عمومية أكثر شفافية وكفاءة واستجابة لتطلعات المواطنين، غير أن ترجمة هذه المبادئ على أرض الواقع المحلي تتطلب فهما عميقا لخصوصيات البيئة المحلية وتحدياتها المؤسسية، فمن بناء القدرات إلى تحسين نظم المعلومات وترسيخ ثقافة الأداء هناك جهد دؤوب ينبغي مواصلته بلا هوادة
ورغم التحديات المتوقعة في البداية فإن المكاسب المنتظرة تستحق الاستثمار والصبر، فتطبيق التخطيط الموجه بالأهداف سيؤدي تدريجيا إلى حوكمة أفضل تنعكس في خدمات تعليمية وصحية ذات جودة أعلى وبنى تحتية مصانة تخدم لمدة أطول ومدن أكثر نظافة ونظاما وأسعارا أكثر استقرارا واستعدادا أقوى للمخاطر والكوارث
أعل الشيخ ولد سييدن
21/09/2025